لماذا لا يكتمل البحث العلمي دون فهم الفروقات الفردية؟
تحليل شامل للفروقات الفردية في البحث العلمي ضمن السياق السعودي والعربي، يكشف كيف يُعيد التعميم إنتاج التفاوت، ويقترح نموذجًا منهجيًا يدمج الثقافة والسياق لصياغة معرفة أكثر عدالة ودقة وفاعلية.
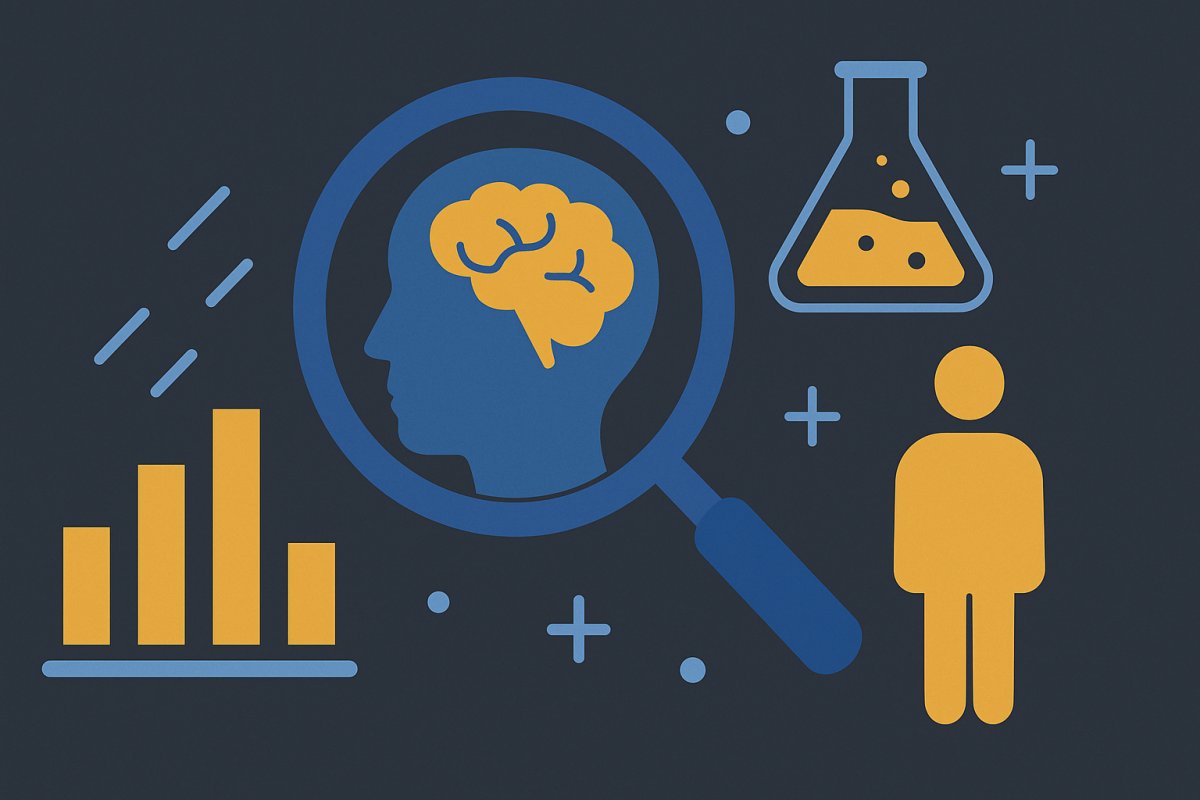
في ظل التحولات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية المتسارعة في المجتمعات العربية والسعودية، تبرز الفروقات الفردية بوصفها حجر الزاوية لفهم السلوك الإنساني، وتوجيه البحوث العلمية والسياسات العامة بشكل أكثر دقة وعدالة. فالفرد لا يُقاس فقط بصفاته الظاهرة، بل بتفاعلاته المعقدة مع السياق الذي يعيش فيه، من حيث العمر، الجنس، الجنسية، الطبقة، الدخل، التعليم، والموقع الوظيفي. يتناول هذا المقال هذه الفروقات من منظور تحليلي متقاطع، مسلطًا الضوء على الحاجة المنهجية والأخلاقية لإعادة توطين المفاهيم الغربية داخل البيئة العربية، وتحديدًا السعودية، حيث تتداخل القيم الدينية والثقافية مع الهياكل المؤسسية لتشكل تجارب فردية واجتماعية متمايزة. إن تجاهل هذه الفروقات لا يؤدي فقط إلى نتائج بحثية مشوشة، بل يفضي إلى سياسات سطحية تُعيد إنتاج التفاوت بدلاً من معالجته.
الفروقات الفردية في البحث العلمي
تُعد الفروقات الفردية مفهومًا مركزيًا في المنهجية العلمية المعاصرة، حيث تشير إلى التباينات الملموسة في الخصائص أو الاستجابات أو النتائج بين الأفراد أو المجموعات، استنادًا إلى عوامل ديموغرافية واجتماعية واقتصادية متعددة. وهذه الفروقات لا تُعتبر مجرد سمات وصفية، بل تمثل متغيرات تحليلية عميقة تؤثر تأثيرًا مباشرًا في تصميم الدراسة، جمع البيانات، تفسير النتائج، وتعميم التوصيات. تشمل هذه الفروقات العمر، الجنس، المستوى التعليمي، الوضع المهني، الطبقة الاجتماعية، مستوى الدخل السنوي للأسرة، بالإضافة إلى العرق والجنسية. ولا تكمن أهمية هذه المتغيرات في كونها تصنيفات سكانية فحسب، بل لأنها تمثل تمظهرًا لتجارب حياتية ونفسية وثقافية مختلفة، تؤثر في طريقة استقبال الأفراد للتجارب، استجابتهم للتدخلات، وتفاعلهم مع الظواهر الاجتماعية والسلوكية قيد الدراسة.
الفروقات الفردية كأداة تحليلية وليست مجرد بيانات توصيفية
لقد دأبت العديد من الدراسات في الفترات السابقة على استخدام هذه الفروقات كمتغيرات ضابطة، دون الغوص في تحليل أبعادها ودلالاتها الاجتماعية والثقافية. ومع تطور المنهجيات البحثية، لم يعد كافيًا تصنيف الأفراد وفقًا لعمرهم أو جنسهم أو مستوى تعليمهم دون تفكيك كيفية تفاعل هذه المتغيرات مع الظواهر المدروسة. على سبيل المثال، لا يُعد العمر متغيرًا زمنيًا فحسب، بل هو مؤشر على المرحلة النفسية-الاجتماعية التي يمر بها الفرد، كما أن الجنس لا يمكن اختزاله إلى البنية البيولوجية دون مراعاة الأدوار الجنسية والسياقات الاجتماعية التي تؤثر في سلوك الأفراد وتصوراتهم الذاتية. وبالمثل، فإن الجنسية ليست مجرد انتماء قانوني، بل ترتبط بمحددات ثقافية وقانونية وسياسية تساهم في تشكيل التجربة الحياتية للفرد. لذلك، لا بد من اعتماد الفروقات الفردية كمنظومة تحليلية متكاملة، تستند إلى مقاربة تفكيكية تقاطعية تعترف بتداخل العوامل وتأثيرها المتبادل، بدلًا من تحليل كل متغير على حدة بمعزل عن الآخر.
خصوصية السياق العربي والسعودي في فهم الفروقات الفردية
عند الانتقال من الإطار النظري العام إلى التطبيقات البحثية في المجتمعات العربية، والسعودية على وجه الخصوص، تظهر تحديات وفرص منهجية فريدة تتطلب إعادة النظر في النماذج المفاهيمية التي طُورت في البيئات الغربية. فالمجتمعات الغربية، كالأمريكية أو الأوروبية، عادة ما تتسم بهياكل اجتماعية أكثر فردانية، وسياقات ثقافية علمانية نسبيًا، بينما يغلب على المجتمعات العربية الطابع الجماعي، وترتبط الأدوار الاجتماعية بديناميات ثقافية ودينية وعشائرية تختلف جذريًا من حيث الشكل والمضمون. في هذا السياق، يُصبح من غير الملائم نقل النماذج الغربية لتحليل الفروقات الفردية دون إعادة تكييفها أو مساءلتها منهجيًا.
فعلى سبيل المثال، لا يحمل مفهوم الطبقة الاجتماعية في السياق السعودي أو الخليجي نفس البنية التي يحملها في السياق البريطاني أو الأمريكي. ففي حين تُبنى الطبقات في الغرب على تراكم رأس المال الاقتصادي والتعليمي، فإنها في السياق السعودي قد تتقاطع مع المحددات القبلية، والانتماء المناطقي، والروابط العائلية، بالإضافة إلى مكونات اقتصادية متغيرة حديثًا. كما أن الفروقات المرتبطة بالجنس لا يمكن فصلها عن منظومة القيم الاجتماعية والدينية التي تشكل دور المرأة ومجال حركتها المهني والأسري، وهي منظومة تختلف جذريًا عن تلك الموجودة في الدول الإسكندنافية أو بعض الدول الآسيوية ذات الخلفيات العلمانية.
ومن جهة أخرى، تكتسب الجنسية أهمية خاصة في السياق الخليجي والسعودي تحديدًا، حيث تترتب عليها فروقات قانونية وإدارية واقتصادية ملموسة في فرص العمل، الوصول إلى الرعاية الصحية، والاندماج الاجتماعي. وبالتالي، فإن تحليل نتائج بحث ما دون مراعاة ما إذا كان المشاركون يحملون الجنسية السعودية أو يحملون إقامات عمل، يُعد خطأً منهجيًا فادحًا يقوّض مصداقية النتائج.
الفشل في إدماج الفروقات الفردية " التعميم الكاذب"
إن تجاهل هذه الفروقات، سواء عن قصد أو بسبب ضعف التصميم البحثي، يُنتج ما يُعرف بـ"التعميم الكاذب"، أي إصدار نتائج تبدو شاملة لكنها في الحقيقة مبنية على شريحة سكانية ضيقة. وهذا النوع من الأخطاء ليس مجرد خلل علمي، بل هو فشل في تحقيق العدالة المعرفية، إذ تُقصى تجارب مجموعات كاملة من التمثيل العلمي. وتنعكس هذه الإشكالية في السياسات المستندة إلى تلك الأبحاث، ما يؤدي إلى تصميم تدخلات غير فعالة أو حتى مُجحفة بحق بعض الفئات. في المجال الصحي مثلًا، تظهر الفروقات في معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة بين الرجال والنساء، لكن الأبحاث التي تُجري التحليل دون تمييز على أساس الجنس قد تُخفي احتياجات النساء وتقلل من فرص وصولهن إلى الرعاية المُصممة خصيصًا لهن. وكذلك في القطاع التعليمي، تؤثر الطبقة الاجتماعية ومستوى دخل الأسرة في تحصيل الطلاب بشكل كبير، لكن غياب هذه المؤشرات من التحليل يُنتج سياسات تعليمية "محايدة" ظاهريًا، لكنها تعيد إنتاج التفاوت القائم على المستوى الفعلي.
في ضوء كل ما تقدم، تبرز الحاجة إلى تطوير نماذج بحثية عربية تستوعب التعقيد الفعلي للواقع الاجتماعي والثقافي في مجتمعاتنا. وهذا لا يعني فقط توطين أدوات القياس أو ترجمتها لغويًا، بل يعني إعادة بناء المنظومة المفاهيمية والمنهجية انطلاقًا من الواقع المعاش. إن تبني نهج تحليلي يأخذ في الاعتبار التفاعل بين السن، والجنس، والموقع الاجتماعي والاقتصادي، والانتماء الثقافي والقانوني، يُمثل خطوة ضرورية نحو إنتاج معرفة أكثر عدالة وشمولًا. كما أن تعزيز ثقافة البحث التي تُراعي هذه الفروقات في مراكز الأبحاث والجامعات العربية سيُساهم في بناء سياسات قائمة على الأدلة الفعلية لا الافتراضات المعيارية.
تُعد الفروقات الفردية مفتاحًا لفهم تعقيدات المجتمعات المعاصرة، لا سيما المجتمعات العربية التي تتميز بتركيبة سكانية متنوعة وسياقات ثقافية مركبة. والتعامل مع هذه الفروقات ليس مسألة فنية أو إحصائية فحسب، بل هو سؤال أخلاقي يرتبط بكيفية تمثيل البشر في العلم، ومن تُمنح له المساحة للتعبير، ومن يُقصى عن التحليل. ومن هذا المنطلق، فإن أي مشروع بحثي يسعى لفهم المجتمع العربي أو السعودي دون مراعاة الفروقات الفردية، سيكون بالضرورة قاصرًا في نتائجه، ومحدود الأثر في تطبيقاته، وقابلًا لإعادة الإنتاج المعرفي غير العادل. ومن هنا تبدأ الحاجة الفعلية إلى علم أكثر وعيًا بالاختلاف، وأكثر التزامًا بالدقة، وأكثر انحيازًا للواقع.
الفروقات المرتبطة بالجنس في البحث العلمي
يُعتبر الجنس أحد أكثر المتغيرات استخدامًا في البحث العلمي، ليس فقط لسهولة تصنيفه البيولوجي إلى ذكور وإناث، بل أيضًا لأنه يرتبط بتباينات فيزيولوجية ونفسية وسلوكية ثبت أثرها في مختلف الحقول العلمية، من الطب إلى التعليم إلى علم النفس الاجتماعي. إلا أن الاستخدام السائد لهذا المتغير غالبًا ما يفتقر إلى الدقة النظرية والمنهجية، حيث يُخلط بين "الجنس" باعتباره تصنيفًا بيولوجيًا، و"النوع الاجتماعي" (الجندر) باعتباره بناءً اجتماعيًا وثقافيًا يُنتج الأدوار والتوقعات السلوكية المرتبطة بكل من الذكور والإناث. وهذا الخلط المفاهيمي يُضعف من قدرة الباحثين على تحليل النتائج بطريقة تُنصف الفروقات الفعلية وتعالج جذورها الاجتماعية والثقافية، لا فقط مظاهرها الظرفية.
في المجتمعات التي تتميز بدرجة عالية من التراتب الجندري، كالمجتمعات العربية والخليجية عمومًا، لا يُمكن اعتبار الفروقات بين الجنسين مجرد اختلافات طبيعية أو حيادية. بل ينبغي النظر إليها كنتاج تاريخي وثقافي لمنظومات اجتماعية تنتج أدوارًا محددة للمرأة والرجل، وتوزع الفرص، وتُعيد تشكيل التوقعات والتفضيلات والسلوكيات اليومية. وهذا ما يجعل من دراسة الجنس في الأبحاث داخل السياق السعودي مسألة علمية ومجتمعية ذات حساسية عالية، تستوجب مستوى عالٍ من الدقة والتأمل النقدي.
التحيز البنيوي في تمثيل الجنس في الدراسات
إن واحدًا من أبرز الإشكاليات التي واجهت البحث العلمي الكلاسيكي هو التحيز البنيوي تجاه الذكور بوصفهم "النموذج المرجعي" أو "المعيار الطبيعي"، بينما تُعامل الإناث باعتبارهن حالة خاصة أو استثناءً. وقد ظهر هذا التحيز جليًا في الدراسات الطبية والنفسية التي كانت تُجرى في الغالب على عينات ذكورية، ويُعمم منها إلى الإناث دون تحقق من مدى مطابقة النتائج أو صلاحيتها. كما بيّنت دراسة Mehta et al. (2016)، فإن العديد من المؤشرات القلبية تختلف لدى النساء، سواء من حيث الأعراض أو الاستجابة للأدوية، ولكن العقود السابقة من البحث الطبي لم تدمج الإناث بشكل متساوٍ في عينات الدراسة، مما أدى إلى نتائج أقل دقة في تشخيص أمراض القلب لديهن.
وهذا التحيز لا يقتصر على مجتمعات الغرب، بل يتفاقم في المجتمعات المحافظة أو الذكورية، حيث تكون مشاركة المرأة في الدراسات أصعب بسبب القيود الاجتماعية، أو حيث يُفترض ضمنيًا أن التجربة الذكورية هي التجربة "الطبيعية". وفي السياق السعودي، فإن هذا التحيز قد يظهر في الدراسات التي تُجرى في المؤسسات التعليمية أو الصحية أو العمالية، حيث تكون العينة مكونة في الغالب من الذكور لسهولة الوصول إليهم، ويتم تعميم النتائج على المجتمع ككل. هذا التعميم يُخفي الفروق الجندرية العميقة التي تؤثر في الصحة النفسية، والرضا الوظيفي، والسلوك الاجتماعي، وحتى في أنماط الاستهلاك واتخاذ القرار.
في الدراسات التي تركز على فهم سلوكيات أو اتجاهات الأفراد، لا ينبغي اعتبار الجنس مجرد متغير وصفي يتم استخدامه للفصل بين المشاركين، بل هو متغير تفاعلي يتداخل مع مجموعة من العوامل الأخرى، مثل العمر، والمستوى التعليمي، والدخل، والحالة الاجتماعية، ليُنتج تجارب حياتية مركبة. فعلى سبيل المثال، لا يمكن اعتبار تجربة امرأة متعلمة وعاملة في بيئة حضرية مثل الرياض مشابهة لتجربة امرأة في بيئة ريفية ذات تعليم منخفض، رغم كونهما تنتميان لنفس التصنيف الجندري. وهذا ما يُعرف في الأدبيات العلمية بـ"التقاطعية" (intersectionality)، أي أن الفروقات لا تتحدد فقط بالجنس بل تتعقد عند تداخله مع متغيرات أخرى.
في المجتمعات العربية، وغالبًا في المجتمع السعودي، تتداخل منظومة القيم التقليدية والدينية مع الأدوار الجندرية بشكل عميق، مما يُنتج تباينات ملموسة في الفرص، وأنماط العمل، والمسؤوليات الأسرية، وحدود الحركة الجسدية والمعنوية. وبالتالي، فإن أي دراسة تتجاهل هذه المحددات، وتتعامل مع "المرأة" أو "الرجل" كمجرد تصنيفين بيولوجيين، تُفقد أدواتها التحليلية كثيرًا من الدقة، وتُصبح عرضة لإنتاج معرفة سطحية أو مضللة.
أثر تمكين المرأة السعودية على البحث العلمي
منذ بداية العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، شهدت المملكة العربية السعودية تحولات اجتماعية واقتصادية كبرى شملت تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في التعليم والعمل والمجال العام. وقد صاحب هذا التحول تغير واضح في الأدوار الجندرية، وفي التصورات المجتمعية عن المرأة، وفي أنماط مشاركتها في سوق العمل، وفي تمثيلها في المناصب القيادية. غير أن هذه التغيرات لا يمكن فهمها دون العودة إلى السياق الثقافي العميق الذي أنتج القيود السابقة، ودون النظر إلى كيفية تفاعل المرأة مع هذه التحولات وفقًا لفئاتها العمرية، ومستواها التعليمي، وموقعها الجغرافي، وانتمائها الطبقي.
تشير الدراسات إلى أن المرأة السعودية تعاني من مستويات أعلى من القلق والتوتر في البيئات المهنية، خاصة في المهن التي كانت تُعتبر حكرًا على الرجال، مثل قطاعات الأمن، والتقنية، والإدارة العليا. وقد وُجد أن هذا التوتر لا يعود إلى نقص الكفاءة أو القدرات، بل إلى الصراع الداخلي بين التطلعات الفردية للمرأة من جهة، والضغوط الاجتماعية والثقافية من جهة أخرى، مما يؤكد أن تحليل الفروقات الجندرية ينبغي أن يتم في إطار ثقافي ونفسي عميق لا سطحي.
إن تجاهل الفروقات الجندرية في تصميم الأبحاث يُفضي إلى نتائج موجهة لفئة واحدة من السكان، غالبًا ما تكون الذكور، وبالتالي فإن البرامج الناتجة عن هذه الأبحاث ستكون غير ملائمة للنساء. أما عندما يتم دمج هذا التحليل بشكل منهجي في مراحل البحث كافة، من التصميم إلى التفسير، فإن ذلك يفتح المجال لفهم أوسع لتجارب النساء والرجال على حد سواء، وبالتالي إنتاج سياسات أكثر عدالة وفعالية. فعلى سبيل المثال، في تصميم حملات التوعية بالصحة النفسية، قد تختلف الرسائل التي تُوجه للنساء عن تلك التي تُوجه للرجال، ليس بسبب اختلاف الأعراض فقط، بل بسبب اختلاف الحواجز الثقافية التي تمنع كل منهما من طلب المساعدة أو التعبير عن الألم النفسي. لا يمكن للعلم أن يدّعي الموضوعية وهو يتجاهل نصف المجتمع، ولا يمكن للنتائج أن تُعتبر ممثلة للواقع وهي مبنية على تحليلات تغفل الأبعاد الجندرية. في السياق العربي والسعودي تحديدًا، حيث يتشابك الدين بالثقافة، والتقاليد بالأدوار الجندرية، فإن فهم الفروقات بين الذكور والإناث لا بد أن يكون عميقًا ومترابطًا، قائمًا على تحليل مركب للتجربة الإنسانية، لا على فصل قاطع بين البيولوجي والاجتماعي. ومن هنا فإن أي توجه بحثي جاد يسعى إلى خدمة مجتمعاتنا لا بد أن يتبنى التحليل الجندري كمسار علمي وأخلاقي في آن معًا.
فهم العرق والجنسية كمحددات معرفية وتجريبية في البحث العلمي
يُعد كل من العرق والجنسية من أكثر المتغيرات حساسية في البحث العلمي، ليس فقط لأنهما يُرتبطان بتاريخ طويل من التمييز والتفاوتات البنيوية، بل لأنهما يعكسان واقعًا معقدًا من التداخلات الثقافية، والسياسية، والاقتصادية التي تُشكل تجارب الأفراد وموقعهم داخل المجتمع. فالعرق لا يُعبّر عن الاختلافات البيولوجية أو الجينية بقدر ما يُعبّر عن انتماءات ثقافية واجتماعية تُمنح للأفراد وتؤطرهم داخل شبكات من الامتيازات أو التهميش، بينما ترتبط الجنسية بمجموعة من الحقوق القانونية والاقتصادية والسياسية التي تُحدد بدقة درجة وصول الفرد إلى الموارد، وفرص العمل، والرعاية، والمشاركة العامة.
وعلى الرغم من أن العرق والجنسية غالبًا ما يُستخدمان في الدراسات الغربية لتحليل قضايا التمييز، وصحة الأقليات، وعدم تكافؤ الفرص التعليمية أو الاقتصادية، إلا أن البحث العلمي في العالم العربي والسعودي على وجه الخصوص لم يُعطِ هذين المتغيرين ما يستحقانه من تحليل وتفكيك، إما بدافع التحفظ الثقافي، أو بسبب افتراض تجانس سكاني وهمي، يُخفي وراءه تباينات جوهرية في ظروف المعيشة والتجربة الاجتماعية.
المجتمع السعودي هو مجتمع متعدد الجنسيات والهويات العرقية
يُعد المجتمع السعودي من أكثر المجتمعات العربية تنوعًا من حيث الجنسية والانتماء الثقافي، سواء على مستوى المواطنين أنفسهم أو على مستوى المقيمين والوافدين. فالنسيج السكاني يشمل مجموعات من أصول مختلفة (نجدية، حجازية، جنوبية، شرقية)، إلى جانب أعداد كبيرة من المقيمين من جنوب آسيا، والشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وأفريقيا جنوب الصحراء، فضلًا عن وجود مجتمعات صغيرة من أصول أوروبية وأمريكية. ورغم أن هذا التنوع يمثل ثروة ثقافية واجتماعية مهمة، إلا أنه يُنتج – في الوقت ذاته – تفاوتات حادة في الفرص، والتمثيل، وتجربة الحياة اليومية، ما يجعله متغيرًا حاسمًا ينبغي تضمينه في التصميمات البحثية وتحليل النتائج.
فمن حيث الجنسية، يتمتع المواطنون السعوديون بحقوق وامتيازات لا تتوفر للمقيمين، سواء من حيث الحصول على التعليم المجاني، أو التوظيف في القطاع العام، أو فرص التملك، أو الاستفادة من البرامج الاجتماعية والصحية المدعومة. هذا التمايز القانوني يُترجم في التجربة اليومية إلى اختلافات ملموسة في جودة الحياة، وإمكانية الترقّي الوظيفي، والحراك الاجتماعي، ومعدلات الضغط النفسي، ومستوى الأمن الوظيفي. لذلك، فإن أي دراسة تُجرى على سكان المملكة دون التمييز بين المواطنين والمقيمين، أو دون تحليل الفروقات على أساس الجنسية، ستُنتج بالضرورة صورة مشوشة عن الواقع.
أما على مستوى العرق والانتماء الثقافي، فهناك تباينات راسخة بين فئات المجتمع، تؤثر على أنماط التفاعل الاجتماعي، وفرص الزواج، واحتمالات التميّز الوظيفي أو الأكاديمي، وغالبًا ما تظهر في صورة أنماط غير مُصرّح بها من التفضيل أو الاستبعاد. هذه التباينات، وإن لم تُقنن بشكل مباشر، إلا أنها تُمارَس ضمنيًا عبر شبكات اجتماعية وثقافية تَحول دون تحقق المساواة الفعلية، وتُنتج آثارًا طويلة الأمد على مستوى الصحة النفسية، والاندماج الاجتماعي، والاستفادة من الفرص.
من الناحية المنهجية، يؤدي تجاهل هذه المتغيرات إلى تقويض مصداقية البحث، لأن البيانات التي تُبنى على عينة مختلطة دون تحليل تمايزاتها تُنتج متوسطات زائفة تُخفي الفروقات الجوهرية. فعلى سبيل المثال، إذا أظهرت دراسة عن "الرضا عن العمل" في مدينة الرياض نتائج إيجابية عامة دون التمييز بين السعوديين والمقيمين من جنسيات آسيوية أو أفريقية، فإننا نكون أمام تعميم يُعطي انطباعًا زائفًا بالرضا العام، في حين أن فئة المقيمين قد تُعاني من ظروف عمل مجهدة، أو غياب الاستقرار، أو ضعف الحوافز، وهي حقائق لا تظهر في المتوسطات الكلية.
كما أن إغفال التحليل العرقي يُخفي الفروقات في التمثيل الأكاديمي والمهني، ومعدلات التهميش أو التفضيل، ويُضعف من القدرة على تفسير بعض النتائج ذات البُعد الاجتماعي أو النفسي. فعلى سبيل المثال، قد تُظهر إحدى الدراسات ارتفاعًا في مستويات التوتر أو القلق بين فئة معينة، دون أن تُدرج ضمن تحليلها البعد العرقي أو الجنسي، رغم أن هذه المتغيرات قد تُفسر نسبة كبيرة من التباين في البيانات.
أهمية دمج العرق والجنسية في تحليل السياسات العامة
إن إدماج متغيرات العرق والجنسية في الأبحاث لا يُعد مجرد تفصيل تقني، بل هو شرط لتحسين جودة السياسات والبرامج، خصوصًا في بلد يستضيف ملايين المقيمين من خلفيات مختلفة. فمثلًا، في سياسات الصحة العامة، لا يمكن تصميم برامج توعية أو تدخلات نفسية دون معرفة اللغات المتحدثة في المجتمع، والخلفيات الثقافية للمستهدفين، ومدى ثقتهم في المؤسسات، وموقعهم القانوني الذي قد يُحدد استعدادهم لطلب المساعدة. وفي التعليم، فإن تنوع خلفيات الطلبة يتطلب مقاربات متعددة ثقافيًا (culturally responsive pedagogies)، تُراعي الفروقات في أساليب التعلم، والدافعية، والتوقعات.
وفي ميدان العمل، تُعد الجنسية أحد أبرز العوامل المحددة للفرص والمسارات المهنية، ليس فقط من حيث السياسات الرسمية، بل من حيث البُنية الاجتماعية غير المكتوبة التي تفضل جنسيات معينة في أدوار محددة، وتستبعد غيرها من الترقّي. وبالتالي، فإن تحليل هذه الديناميات ضروري لفهم تكوين القوى العاملة، ومستوى العدالة التنظيمية، وفاعلية برامج السعودة والتوطين.
يمثل العرق والجنسية بُعدين حاسمين في فهم التجربة الإنسانية داخل أي مجتمع، خاصة في مجتمع متنوع ومعولم كالمجتمع السعودي. والتعامل مع هذين البُعدين لا ينبغي أن يكون محكومًا بالتحفظ أو الحساسية السياسية، بل بالوضوح العلمي والمسؤولية المعرفية. فالعلم، لكي يكون صادقًا، لا بد أن يُنير الفروقات لا أن يُخفيها، وأن يُحلل الواقع كما هو لا كما يُراد له أن يبدو. وفي هذا الإطار، فإن إدماج العرق والجنسية في التصميم البحثي وتحليل النتائج يُعد ضرورة معرفية وأخلاقية، لا فقط خيارًا منهجيًا، لأنه يُعيد الاعتبار لأصوات وتجارب قد لا تكون مُمثّلة في الخطاب الرسمي أو الإعلامي، لكنه يُمكن أن تكون حاسمة في فهم المجتمع وتحسين سياساته.
الفروقات المرتبطة بالعمر في البحث العلمي
رغم أن العمر يُعد في الظاهر من أسهل المتغيرات في التصنيف والقياس، نظرًا لطبيعته الرقمية المباشرة، إلا أنه في التحليل العميق لا يُمثل مجرد عدد السنوات التي عاشها الإنسان، بل يُجسد موقعًا اجتماعيًا وثقافيًا ونفسيًا معقدًا. فالعمر لا يُحدد فقط من خلال الزمن البيولوجي، بل من خلال موقع الفرد في دورة الحياة، وما يترتب على هذا الموقع من توقعات اجتماعية، وأدوار، وحقوق، والتزامات، وأحيانًا وصمات. ولهذا السبب، فإن اختزال العمر في متغير رقمي جامد يُفقد البحث أداة تحليلية مهمة تكشف الكثير عن التفاوتات في التجربة الإنسانية.
في السياق العربي عمومًا، والسعودي على وجه الخصوص، فإن الفئات العمرية لا تُعامل باعتبارها مراحل زمنية متساوية، بل تُحاط بمعانٍ ثقافية ودينية واجتماعية تُضفي على كل مرحلة دلالات ومعايير تختلف جذريًا عن تلك المعتمدة في المجتمعات الغربية أو الآسيوية. فمرحلة الطفولة تُربط غالبًا بالبراءة والرعاية الشاملة، في حين تُحمَّل مرحلة الشباب آمالًا اجتماعية واقتصادية كبيرة، أما مرحلة الشيخوخة فهي في بعض الأحيان تُقدَّر بوصفها مصدرًا للحكمة، وأحيانًا تُهمَّش بوصفها خروجًا عن أدوار الفاعلية.
التحليل العلمي للعمر في الابحاث والعلوم النفسية والاجتماعية
تشير الأدبيات النفسية إلى أن التغيرات المرتبطة بالعمر تشمل الأبعاد الإدراكية، والانفعالية، والسلوكية، كما تؤثر في أنماط اتخاذ القرار، والتفاعل مع الضغوط، والاستجابة للتدخلات النفسية أو الاجتماعية. فعلى سبيل المثال، أظهرت دراسات عديدة أن المراهقين يتميزون بارتفاع مستويات القلق الاجتماعي، في حين أن كبار السن قد يُظهرون درجات أعلى من الرضا الذاتي لكن مع تزايد مشاعر الوحدة أو الخوف من فقدان السيطرة (Charles & Carstensen, 2010).
أما في البحوث الصحية، فقد تبين أن بعض الأدوية أو الأنظمة العلاجية تُظهر فعالية مختلفة تبعًا للمرحلة العمرية، مما يُحتّم ضرورة تضمين الفئات العمرية كمتغير رئيسي في التحليل الإحصائي، لا مجرد عامل توصيفي. وفي ميدان التعليم، تتغير القدرات على التعلم والاندماج بحسب العمر، سواء في المراحل المدرسية أو في برامج التعليم مدى الحياة، ما يجعل من الضروري دراسة الفروق في أساليب التعليم والدافعية بين الأطفال والبالغين. غير أن الكثير من هذه الاستنتاجات المستندة إلى بحوث عالمية، لا يمكن تعميمها تلقائيًا على السياق السعودي، دون مراعاة الخصوصية الثقافية التي تؤطر الفئات العمرية داخل معايير مجتمعية ذات طابع ديني وأخلاقي وتاريخي مختلف.
في المجتمع السعودي، تكتسب الفئات العمرية معانٍ ثقافية مركّبة، حيث لا يُنظر إلى السن بوصفه تطورًا بيولوجيًا فحسب، بل كإطار لأدوار متوقعة اجتماعيًا. فعلى سبيل المثال، يُنظر إلى مرحلة الشباب، خاصة الذكور، على أنها مرحلة اكتمال الرجولة وتحمل المسؤولية، ويرتبط بها الانتقال إلى الاستقلال الاقتصادي والزواج وتأسيس الأسرة. أما بالنسبة للنساء، فإن مرحلة البلوغ ترتبط غالبًا بتغيرات في الأدوار الاجتماعية، وأحيانًا بالقيود المفروضة على الحركة والقرار، بناءً على تصورات ثقافية عن الأنوثة والنضج.
وفي المقابل، يُنظر إلى الشيخوخة على نحو مزدوج: فهي مرحلة يُفترض فيها أن تُحاط بالاحترام والتوقير، ولكنها عمليًا قد تشهد في بعض الأحيان تراجعًا في الأدوار الاجتماعية، خاصة مع التحول نحو الحياة الحضرية الحديثة التي تضعف فيها الروابط الأسرية التقليدية. وقد أشارت دراسات محلية إلى أن كبار السن في المملكة يعانون من درجات متفاوتة من العزلة، خصوصًا أولئك الذين يعيشون في المدن الكبرى بعيدًا عن أبنائهم أو عائلاتهم الموسعة. وتُعتبر الطفولة كذلك مرحلة حساسة في الثقافة السعودية، حيث يتمتع الأطفال بالرعاية الاجتماعية والدينية العالية، ولكن في الوقت نفسه، قد تواجه برامج الطفولة تحديات تتعلق بتوحيد أساليب التربية بين الأجيال، وتضارب التوجهات بين التقاليد والقيم الحديثة، ما يؤثر في الصحة النفسية والمعرفية للأطفال، ويُصعّب تقييمهم وفق معايير غير محلية.
تأثير العمر في نتائج الدراسات داخل السياق المحلي
من الناحية التطبيقية، فإن الفشل في التفريق بين الفئات العمرية عند تحليل نتائج الدراسات يؤدي إلى استنتاجات سطحية قد تُخفي تباينات جوهرية. فعند دراسة "الرضا عن الحياة" مثلًا، قد تُظهر النتائج العامة مستوى جيدًا من الرضا لدى السعوديين، لكن عند التحليل التفصيلي يتبين أن كبار السن يُظهرون رضا أعلى رغم انخفاض دخولهم، بينما الشباب يُظهرون توترًا وعدم استقرار بسبب ضغط التوقعات، وصعوبة دخول سوق العمل، والقلق من المستقبل. وكذلك، فإن تقييم فعالية برنامج توعوي في الصحة النفسية دون تحليل استجابة المراهقين بشكل منفصل عن استجابة البالغين، يُضعف من دقة التوصيات المستخلصة.
أهمية مراعاة العمر في السياسات العامة والبرامج الاجتماعية
تُعد مرحلة العمر محددًا جوهريًا في توجيه السياسات العامة، بدءًا من التعليم والصحة، وصولًا إلى برامج الدعم الاجتماعي والتخطيط الحضري. فعلى سبيل المثال، تزايد أعداد الشباب في السعودية يجعل من الضروري أن تُصمم البرامج الشبابية بشكل يتناسب مع احتياجاتهم النفسية والاقتصادية، بدلًا من استخدام نماذج جاهزة مأخوذة من مجتمعات ذات هياكل عمرية مختلفة. كما أن التحولات الديموغرافية نحو شيخوخة تدريجية للمجتمع تتطلب إعادة النظر في نظام الرعاية الصحية والاجتماعية، وتطوير استراتيجيات طويلة الأمد للعناية بكبار السن، بما يُحافظ على كرامتهم واستقلالهم. أما في ميدان العمل، فإن إدماج الفئات العمرية المختلفة يُعزز من التنوع المعرفي داخل المؤسسات، ويسمح بالاستفادة من الخبرات المتراكمة، والطاقات الإبداعية، بشرط أن تُراعى اختلافات الدافعية والتوقعات والأداء. وهذا يتطلب إعادة صياغة أنظمة التدريب والترقي والتقاعد، وفق مقاربة تراعي العمر لا تقصي منه أحدًا.
لا يُمكن فهم السلوك البشري ولا تفسير التجربة الاجتماعية من دون اعتبار العمر كعدسة تحليلية تكشف عن مراحل متمايزة في تطور الفرد واستجابته للمتغيرات. وفي السياق السعودي، تكتسب هذه العدسة أهمية مضاعفة بسبب البنية الثقافية التي تُضفي على الفئات العمرية أدوارًا ومعاني تختلف جذريًا عن تلك المتداولة في الأدبيات الغربية. ومن هنا، فإن أي باحث أو صانع قرار يتجاهل هذه الفروقات، إنما يُنتج معرفة منقوصة، ويفشل في تصميم تدخلات فعّالة. فالعمر، وإن بدا رقمًا بسيطًا في استبيان، إلا أنه يحمل وراءه عالَمًا من التجارب، والفرص، والقيود، التي يجب أن تُقرأ بعين علمية ووعي ثقافي.
الطبقة الاجتماعية ومستوى دخل الأسرة في البحث العلمي
لطالما شكّل كل من الطبقة الاجتماعية ومستوى دخل الأسرة عنصرين رئيسيين في تحليل البُنى الاجتماعية وتأثيرها على سلوك الأفراد وفرصهم. إلا أن التعامل مع هذين المتغيرين في الكثير من الدراسات، لا سيما في السياق العربي، ظل في إطار الوصف الإحصائي أو الفئوي، دون الغوص في المعنى البنيوي الذي يحملهما، والذي يُعبّر عن موقع الفرد داخل نظام اجتماعي واقتصادي متشابك، يحدد بشكل غير مباشر فرصه في التعليم، الصحة، التوظيف، والمشاركة العامة. وفي هذا الإطار، لا يمكن فهم تأثير الطبقة والدخل على نتائج البحث إلا باعتبارهما محددات سياقية تُنتج أنماطًا مختلفة من التجربة البشرية، لا فقط فروقات كمية في الموارد. فالطبقة الاجتماعية، كما تفهم في السوسيولوجيا الحديثة، لا تُقاس فقط بالدخل أو المستوى التعليمي، بل تشمل أيضًا الرموز الثقافية، وأنماط الاستهلاك، والعلاقات الاجتماعية، والقدرة على التأثير. وتُظهر الأدبيات الكلاسيكية والمعاصرة – من كارل ماركس إلى بيير بورديو – أن الطبقة ليست فقط موقعًا في السلم الاقتصادي، بل هي شكل من أشكال الوجود الاجتماعي الذي يحدد كيفية رؤية الفرد لنفسه، وتفاعله مع المؤسسات، وحدود طموحه، وحتى نظرته إلى العدالة والنجاح.
في السياق السعودي، كانت البنية الطبقية تاريخيًا ترتبط بشكل وثيق بالانتماءات القبلية والمناطقية، وكانت تعبيرًا عن التراتب الرمزي أكثر من كونها محددة بالدخل النقدي وحده. ومع تطور الدولة الحديثة، وبدء برامج التنمية الاقتصادية منذ السبعينات، بدأ يتبلور شكل جديد للطبقة الوسطى، خاصة مع توسع قطاعات التعليم والعمل الحكومي، وانتشار فرص الابتعاث، وتملك المساكن، مما أدى إلى إعادة رسم الخريطة الطبقية وفق معايير جديدة، أبرزها الدخل السنوي، الوظيفة، المستوى التعليمي، وأنماط الحياة.
ومع التحول الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده المملكة في العقد الأخير، بدأت تظهر طبقات جديدة ومختلطة من حيث التكوين، حيث تضم كل منها أفرادًا من خلفيات متنوعة، لكنهم يجتمعون في خصائص اقتصادية أو ثقافية متشابهة، مثل الطبقة الوسطى الجديدة التي تميل إلى العمل في القطاعات الخاصة، وتُظهر ميلًا أعلى للاستهلاك، لكنها قد تعاني من انعدام الأمان الوظيفي. وتُقابلها طبقة عاملة ذات دخول متدنية، وغالبًا ما تضم مقيمين أو مواطنين يعملون في مهن منخفضة المهارة أو بلا عقود مستقرة، وتفتقر إلى الأمان المالي والتغطية الصحية المناسبة.
عند استخدام "مستوى دخل الأسرة السنوي" كمتغير في الدراسات، غالبًا ما يتم تصنيفه إلى فئات (منخفض، متوسط، مرتفع)، دون التحليل الكافي للتأثيرات التي يُحدثها هذا الدخل في نمط حياة الأسرة، وتصوراتها للمستقبل، ومدى قدرتها على الوصول للخدمات، أو الانخراط في البرامج الحكومية أو السوقية. فالدخل لا يُحدد فقط القدرة الشرائية، بل هو مرآة للفرص والإمكانات، وهو مؤشر على نوعية الغذاء، ومستوى التعليم، ودرجة التثقيف الصحي، ونمط الترفيه، وطبيعة العلاقات الاجتماعية، وهو أيضًا أحد أقوى المؤشرات المرتبطة بالصحة النفسية والبدنية.
تشير دراسات عالمية – وأخرى بدأت بالظهور في العالم العربي – إلى أن الأسر ذات الدخل المنخفض تُظهر معدلات أعلى من القلق والاكتئاب، بسبب الضغوط المالية المستمرة، ومحدودية الخيارات. كما أظهرت البحوث أن الأطفال المنتمين إلى هذه الأسر يعانون من فجوات تعليمية تبدأ في المراحل المبكرة، وتستمر حتى التعليم العالي، حيث يتقلص احتمال دخولهم للتخصصات العلمية أو الجامعات المرموقة مقارنة بأقرانهم من الأسر ذات الدخل المرتفع.
عند إجراء الدراسات الميدانية أو تحليل الاتجاهات السلوكية أو النفسية، يؤدي تجاهل الطبقة الاجتماعية والدخل إلى تعميم مضلل، حيث تُظهر النتائج انطباعات موحدة تخفي خلفها تجارب متباينة جوهريًا. فعلى سبيل المثال، إذا أجريت دراسة حول الرضا عن جودة الحياة في السعودية، وتم جمع البيانات من مشاركين معظمهم من الطبقة المتوسطة العليا، فإن النتيجة النهائية ستكون إيجابية ظاهريًا، لكنها لا تُعبّر عن واقع الفئات ذات الدخل المحدود، والتي تواجه تحديات في السكن، والتعليم، والنقل، والرعاية الصحية. وبالمثل، فإن سياسات الدعم الاجتماعي أو التوظيف أو التعليم التي تُبنى على نتائج أبحاث غير طبقية، غالبًا ما تُفيد الفئات التي كانت أصلًا في موقع أفضل، بينما تُهمل الفئات الأقل حظًا، مما يؤدي إلى تعميق الفجوة، وإعادة إنتاج اللامساواة تحت مظلة الخطاب العلمي أو البرامجي "الحيادي".
لفهم أثر الطبقة الاجتماعية والدخل في نتائج الأبحاث بطريقة أكثر عدالة ودقة، لا بد من تبني ما يُعرف بالمقاربة التقاطعية، أي تحليل تفاعل الطبقة مع متغيرات أخرى مثل الجنس، والعمر، والموقع الجغرافي، والمستوى التعليمي. فامرأة سعودية من أسرة ذات دخل منخفض في منطقة ريفية تعيش تجربة تختلف تمامًا عن رجل من أسرة ميسورة في مدينة كبرى، حتى وإن تشابه كلاهما في العمر أو الوظيفة. كذلك، فإن التحليل المتموضع (Situated Analysis) الذي يضع البيانات في سياقها الاجتماعي والثقافي، يُعد شرطًا أساسيًا لفهم المعنى العميق للطبقة، وليس فقط تمثيلها العددي.
لا يمكن للبحث العلمي أن يُنتج معرفة حقيقية وفعالة دون أن يعترف بأن الأفراد لا يعيشون تجاربهم بمعزل عن الطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها، ولا بمعزل عن دخل أسرهم، وما يتيحه أو يمنعه من فرص. وفي المجتمعات التي تمر بتحولات سريعة كالتي نشهدها في السعودية، فإن الفروقات الطبقية تزداد وضوحًا لا تقلصًا، ما يجعل من الضروري أن تصبح هذه الفروقات جزءًا أساسيًا في تصميم أي دراسة، وتفسير نتائجها، وصياغة توصياتها.
إن إدماج الطبقة والدخل في التحليل ليس مسألة تقنية أو تفصيلية، بل هو موقف علمي وأخلاقي يُعيد التوازن للمعرفة، ويضمن أن تكون السياسات نابعة من واقع متعدد لا من متوسطات مخادعة. ومن هذا المنطلق، فإن أي باحث يتجاهل هذا البُعد في المجتمع السعودي، يفوّت فرصة حقيقية لفهم القوى الفاعلة التي تُشكّل حياة الأفراد، ويُساهم، ولو دون قصد، في تكريس نماذج معرفية لا تُنصف الواقع.
المستوى التعليمي في البحث العلمي
يُعامل "المستوى التعليمي" في كثير من الدراسات بوصفه متغيرًا توصيفيًا يُستخدم في تقسيم العينة إلى فئات مثل "ابتدائي"، "ثانوي"، "جامعي"، "دراسات عليا". غير أن هذا التوصيف السطحي لا يُعبر عن الأثر العميق للتعليم بوصفه منظومة ثقافية واقتصادية واجتماعية تُشكّل وعي الأفراد، وتُحدد آفاقهم، وتُعيد تشكيل علاقاتهم بالمؤسسات والمجتمع. فالتعليم لا يزود الفرد بالمعرفة فحسب، بل يُعيد تعريف موقعه في السلم الاجتماعي، ويمنحه – أو يحرمه – من أدوات الفهم والتحليل، والتعبير عن الذات، واتخاذ القرار. وفي السياق العلمي، يُعد المستوى التعليمي أحد أكثر المتغيرات التي تُفسّر الفروق في المواقف والقيم والسلوكيات. فالفرد الحاصل على تعليم جامعي أو عالٍ غالبًا ما يُظهر درجات أعلى من الانفتاح، والقدرة على التعامل مع المعلومات، والميل إلى التفكير النقدي، مقارنة بمن لم يتجاوز التعليم الأساسي. وهذا الفارق ينعكس في نتائج البحوث التي تتناول موضوعات تتعلق بالصحة، أو الاتجاهات الاجتماعية، أو السلوك الاقتصادي، أو استخدام التكنولوجيا، أو المشاركة في الشأن العام.
شهدت المملكة العربية السعودية تطورًا هائلًا في قطاع التعليم خلال العقود الخمسة الماضية، حيث انتقل المجتمع من معدلات أمية مرتفعة في منتصف القرن العشرين إلى نسبة تعليم عالية شملت الذكور والإناث، في الريف والحضر، مع توسع الجامعات وبرامج الابتعاث والبعثات التعليمية. وقد أدى هذا التحول إلى نشوء طبقة وسطى تعليمية واسعة، وساهم في إعادة تشكيل توزيع الفرص بين الأجيال والمناطق والفئات.
لكن هذا التحول لم يكن متوازنًا من حيث النوع أو الجغرافيا أو التخصص، فبينما ارتفعت نسبة النساء في التعليم العالي، لا سيما في التخصصات الأدبية والطبية، بقي تمثيلهن في بعض التخصصات العلمية والهندسية منخفضًا. كما أظهرت الإحصاءات فروقات بين المناطق، حيث لا تزال بعض المناطق الريفية تُعاني من فجوات في فرص التعليم العالي مقارنة بالمدن الكبرى. كذلك، يواجه خريجو بعض التخصصات تحديات في سوق العمل، ما أدى إلى إعادة طرح سؤال جوهري: هل كل تعليم يُنتج فرصًا متكافئة؟ وهل المستوى التعليمي وحده كافٍ لفهم موقع الفرد، أم ينبغي ربطه بسياقه الطبقي والمهني والجندري؟
العلاقة بين التعليم ومخرجات الأبحاث في السياق العربي
تشير الدراسات إلى أن التعليم يُعد من أقوى العوامل التي تُفسر الفروقات في المواقف من قضايا اجتماعية وثقافية مثل المشاركة السياسية، والمساواة بين الجنسين، وحرية التعبير، وتقبل الآخر، والانخراط في العمل التطوعي. كما أنه يُعد مؤشرًا هامًا لفهم تفاعل الأفراد مع الأبحاث الصحية والنفسية، حيث ينعكس في فهم التعليمات الطبية، أو الالتزام بالعلاج، أو الاستجابة للمقاييس النفسية.
في السياق السعودي والعربي، يكتسب التعليم أبعادًا إضافية، حيث لا يُنظر إليه فقط كأداة للمعرفة، بل كرمز للمكانة الاجتماعية. فالشهادة الجامعية تُعد لدى العديد من الأسر مؤشرًا على "النجاح" و"الوجاهة"، حتى لو لم تُترجم إلى وظيفة مناسبة. كما أن التعليم العالي غالبًا ما يُستخدم كمعيار في اختيار الشريك، أو في قبول الأفراد ضمن شبكات اجتماعية معينة، ما يُظهر دوره كمحدد لهوية الفرد وموقعه الطبقي، وليس فقط كأداة معرفية.
الكثير من الدراسات الميدانية تختزل التعليم في عدد سنوات الدراسة أو نوع الشهادة، دون النظر إلى نوعية التعليم، أو جودة المؤسسة التعليمية، أو لغة التدريس، أو تخصص الدراسة، وكلها عوامل تُحدث فروقات نوعية في نتائج الأبحاث. فمثلًا، لا يمكن اعتبار شخصين يحملان شهادة بكالوريوس في الاقتصاد من جامعتين مختلفتين – إحداهما عالمية باللغة الإنجليزية، والأخرى محلية باللغة العربية – على نفس الدرجة من حيث التكوين المعرفي، أو القدرة على استخدام المفاهيم التحليلية، أو فهم الأدوات الإحصائية في الدراسات الاجتماعية.
كذلك، فإن تجاهل التعليم في تحليل نتائج الأبحاث السلوكية أو الصحية أو الاقتصادية يؤدي إلى تعميمات خطيرة. فعندما تُظهر نتائج استطلاع أن غالبية المشاركين يعارضون فكرة ما أو يرفضون سلوكًا معينًا، دون تحليل مستوياتهم التعليمية، فإن النتيجة قد تُخفي أن هذا الرفض يتركز في شريحة معينة، بينما تُظهر الشرائح الأعلى تعليمًا مواقف مغايرة.
يرتبط التعليم أيضًا بدرجة الثقة في المؤسسات، والقدرة على فهم السياسات العامة، والميل إلى المشاركة المدنية. فالأفراد ذوو التعليم العالي غالبًا ما يُظهرون وعيًا أكبر بالحقوق، ونقدًا أكثر تنظيمًا، واستعدادًا أعلى للتفاعل مع البرامج الحكومية أو التقييمات العلمية. وهذا ما يجعل من الضروري أن تُصمم الأدوات البحثية والبرامج التوعوية والتعليمية بشكل يتناسب مع اختلاف القدرات والفهم والمعرفة، لا أن تُفرض بلغة موحدة لا تراعي التمايزات.
يُعد التعليم أكثر من مجرد متغير ديموغرافي؛ إنه محور من محاور التشكيل الاجتماعي والثقافي للفرد، ومفتاح لفهم تباينات عميقة في المواقف والسلوكيات. وفي المجتمع السعودي، حيث أصبح التعليم أداة للتنقل الطبقي، والارتقاء الاجتماعي، والتعبير عن الذات، فإن إدماجه في التحليل العلمي يُمثل ضرورة منهجية لا غنى عنها. كما أن تجاهله أو تبسيطه يُنتج نتائج مغلوطة، وسياسات غير مستجيبة للفروق الواقعية.
إن الأبحاث التي تُراعي المستوى التعليمي بدقة، وتُحلل آثاره بالربط مع السياق الجندري والمناطقي والطبقي، هي وحدها القادرة على أن تُنتج معرفة تصلح لتوجيه القرارات، وتصميم البرامج، وبناء السياسات. فالعلم، لكي يكون مفيدًا، يجب أن يُنصت للعلم ذاته أولًا، ثم للواقع الذي يُحاول فهمه.
المستوى الوظيفي في البحث العلمي
إن استخدام "المستوى الوظيفي" كمتغير في البحث العلمي لا ينبغي أن يقتصر على مجرد تصنيف الأفراد بحسب نوع العمل الذي يمارسونه أو القطاع الذي ينتمون إليه، بل يجب النظر إليه بوصفه مؤشرًا معقدًا لموقع الفرد في البنية الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية. فالمستوى الوظيفي لا يُحدد فقط طبيعة المهام اليومية التي يؤديها الفرد، بل يُترجم إلى شكل العلاقة مع السلطة، ودرجة السيطرة على بيئة العمل، وسعة الخيارات المهنية، ونوعية الحوافز، والأمان الوظيفي، وساعات العمل، وتوازن الحياة الشخصية والمهنية.
ووفقًا للأدبيات السوسيولوجية والنفسية المعاصرة، فإن المستوى الوظيفي يُعد من أبرز محددات الهوية المهنية، و"الرضا عن الذات"، والإحساس بالجدارة، وهو أيضًا أحد أقوى العوامل التي ترتبط مباشرة بـالصحة النفسية، ومستويات التوتر، والرضا عن الحياة. وقد أظهرت العديد من الدراسات أن الأفراد في المستويات الوظيفية العليا – التي تتمتع بالاستقلالية والسلطة والمرونة – يُظهرون مستويات أعلى من الرضا، وانخفاضًا في معدلات التوتر، مقارنة بالعاملين في المستويات الدنيا، ممن يعملون في بيئات روتينية ضاغطة، ويفتقرون إلى التحكم أو التقدير.
تحولات سوق العمل في السعودية
يشهد سوق العمل السعودي منذ سنوات تحولات عميقة نتيجة برامج التحول الوطني، وتوسّع القطاع الخاص، وتعزيز التوطين، وإعادة هيكلة سوق العمل بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030. وقد ترتّب على ذلك تغير ملموس في المستويات الوظيفية المتاحة، من حيث توزيعها بين المواطنين والمقيمين، وبين النساء والرجال، وبين المراكز العليا والوظائف التنفيذية والميدانية. في هذا السياق، أصبحت الوظائف الإدارية العليا، وقطاعات التقنية والابتكار، ومجالات الاستثمار وريادة الأعمال، أكثر جذبًا للنخبة المتعلمة والميسورة، في حين بقيت الوظائف منخفضة المهارة أو ذات الدخل المحدود محصورة في فئات سكانية معينة، وغالبًا ما يشغلها المقيمون أو المواطنون من خلفيات اجتماعية واقتصادية أقل حظًا. هذا التوزيع يُنتج – دون تصريح – طبقات وظيفية تحمل معها أنماطًا مختلفة من التجربة المعيشية والنفسية، تؤثر بشكل مباشر في استجابات الأفراد في الأبحاث، وتفاعلاتهم مع الظواهر المدروسة.
أثر المستوى الوظيفي على نتائج الدراسات النفسية والسلوكية
تشير الدراسات النفسية إلى أن هناك علاقة طردية بين المستوى الوظيفي ومستوى الرضا العام، والإحساس بالسيطرة، والتوجه نحو الإنجاز، وانخفاض التوتر. الأفراد الذين يشغلون مناصب إشرافية أو إدارية عليا عادة ما يتمتعون بقدر أعلى من التحكم في جدولهم، وبفرص أكثر للنمو، مما ينعكس في تقييمهم الإيجابي لحياتهم، ومرونتهم النفسية، وقدرتهم على اتخاذ القرارات بثقة. وفي المقابل، تظهر الدراسات أن الأفراد الذين يشغلون وظائف ميدانية أو روتينية أو شاقة بدنيًا يعانون من معدلات أعلى من الإرهاق، والتعرض للضغوط، ومشكلات الصحة النفسية. وفي السياق السعودي، يتداخل هذا البُعد النفسي مع البُعد الاجتماعي والثقافي، إذ يُنظر إلى المهن وفق تراتبية اجتماعية غير مكتوبة، حيث تحتل بعض الوظائف مكانة رمزية أعلى (كالطبيب، المهندس، المدير التنفيذي)، بينما يُنظر إلى وظائف أخرى نظرة دونية، حتى لو كانت مصدر دخل ثابت، مما يُضيف بعدًا نفسيًا إضافيًا للمستوى الوظيفي يتمثل في الاعتراف الاجتماعي أو غيابه.
الفروق الوظيفية تؤثر أيضًا في أنماط العلاقة بين الأفراد والمؤسسات. فالموظفون في المناصب العليا غالبًا ما يتمتعون بدرجة أعلى من التفاعل مع القرارات المؤسسية، ويُشاركون في التقييم والتخطيط، مما يُعزز لديهم الشعور بالتمكين والمسؤولية. بينما يُعامل الموظفون في المستويات الدنيا كمنفذين، دون إشراك فعلي، مما يُضعف من ارتباطهم بالمؤسسة، ويجعلهم أكثر عرضة للاحتراق الوظيفي، وفقدان الحافز، والانفصال العاطفي عن العمل. وفي الدراسات التي تتناول الرضا الوظيفي أو الانتماء المؤسسي أو الالتزام المهني، فإن تجاهل المستوى الوظيفي يُنتج نتائج عامة لا تعكس الواقع، وقد تؤدي إلى تصميم تدخلات موجهة للفئة الخطأ، أو مبنية على تقييم إيجابي يخفي وراءه استياءً واسعًا في المستويات الدنيا.
التفاوتات الجندرية والمناطقية داخل المستويات الوظيفية
من المهم التنبيه إلى أن المستوى الوظيفي لا يتحدد فقط بالمسمى الوظيفي، بل يتقاطع مع عوامل أخرى مثل الجنس، والموقع الجغرافي، والخلفية التعليمية. فعلى سبيل المثال، قد تكون المرأة السعودية التي تعمل في وظيفة إدارية في مدينة كبرى تتمتع بامتيازات ومرونة لا تتوفر لرجل يعمل في وظيفة ميدانية في منطقة نائية. كما أن النساء عمومًا ما يواجهن صعوبات في الوصول إلى المستويات الإدارية العليا بسبب القيود الثقافية أو ضعف الفرص، رغم امتلاكهن مؤهلات معادلة أو أفضل من الرجال، مما يجعل من المستوى الوظيفي مؤشرًا غير مكتمل ما لم يُحلل داخل إطاره الاجتماعي والتقاطع مع الجندر والمكان.
ZDataCloud: نحو عدالة بحثية متقدمة عبر ضبط الفروقات الديموغرافية
في عصر تتطلب فيه البحوث الاجتماعية والديموغرافية دقة بالغة وتمثيلًا منصفًا لكافة شرائح المجتمع، يبرز نظام ZDataCloud بوصفه أداة تقنية ومعرفية متقدمة تُعيد تشكيل العلاقة بين الباحث والعينة، ليس فقط على مستوى جمع البيانات، بل على مستوى ضمان العدالة البحثية والتحكم الفعال في التمثيل الديموغرافي.
يمكّن النظام الباحث من تحديد خصائص العينة بدقة بالغة قبل بدء الدراسة، مثل الجنس، العمر، الجنسية، المستوى التعليمي، الطبقة الاجتماعية، الموقع الجغرافي، والمستوى الوظيفي، مما يُقلل من خطر التحيز العشوائي أو التحيز البنيوي الناتج عن العينات غير المتوازنة. وهذا التخصيص المسبق يُعد من أبرز نقاط التحول في البحوث الاجتماعية، التي غالبًا ما كانت تتعثر في مرحلة ما بعد التحليل، بسبب عينة لا تعكس الواقع السكاني المتنوع.
التحكم المسبق لا الاحتمال العشوائي
واحدة من أبرز مزايا ZDataCloud تكمن في قدرته على بناء العينة وفق خصائص ديموغرافية متعددة متداخلة، وليس وفق متغير واحد منعزل. فبدلًا من اختيار "النساء" كفئة واحدة، يمكن للنظام جمع عينة من "نساء سعوديات من الفئة العمرية 25-34، حاملات لشهادة جامعية، يعملن في القطاع الخاص، في المنطقة الشرقية"، وهو ما يسمح بتحقيق تحليل تقاطعي حقيقي يعكس تعقيدات الواقع الاجتماعي.
التمثيل العادل لمجموعات مهمّشة
غالبًا ما تعاني الفئات المهمّشة (مثل ذوي الدخل المنخفض، أو المقيمين من جنسيات محددة، أو النساء في مهن غير تقليدية) من ضعف التمثيل في البحوث، وهو ما يُنتج فجوات معرفية وسياسات غير متكافئة. لكن باستخدام أدوات ZDataCloud، يستطيع الباحث استهداف هذه الفئات بشكل مباشر، مما يرفع من جودة النتائج ويُعزز العدالة المعرفية.
إغلاق فجوة "التعميم الكاذب"
كثير من الدراسات الاجتماعية تُتهم بإنتاج تعميمات غير دقيقة مبنية على بيانات مقتطعة من طبقات متشابهة أو بيئات محدودة. ZDataCloud يُغلق هذه الفجوة من خلال إتاحته تصفية دقيقة تضمن تنوعًا شاملاً في العينة، وتسمح للباحث بمقارنة البيانات بين الفئات المختلفة بطريقة عادلة ومبنية على معايير موضوعية.
ZDataCloud في السياق السعودي: من التمثيل الإحصائي إلى التمثيل المجتمعي العادل
أثبت نظام ZDataCloud فاعليته في عدد من المشاريع البحثية التي جرت في السعودية خلال السنوات الأخيرة، خصوصًا في الدراسات المرتبطة بتحليل الاتجاهات المجتمعية، الصحة النفسية، الرضا عن جودة الحياة، تمكين المرأة، وتفاعل الشباب مع سوق العمل. وتبرز هذه الفاعلية من خلال قدرته على ضبط العينة بناءً على الخصائص الديموغرافية الدقيقة للمجتمع السعودي، بما يضمن عدالة التمثيل وتحقيق نتائج قابلة للتعميم المنصف.
1. تمثيل دقيق لمجموعات متباينة في مشروع "رضا المواطنين عن جودة الحياة" (2023)
في دراسة ميدانية جرت بالتعاون مع جهة حكومية محلية لقياس رضا المواطنين عن برامج جودة الحياة، استخدم الفريق البحثي نظام ZDataCloud لتحديد خصائص العينة بدقة، بحيث شملت:
-
ذكور وإناث بنسب متساوية.
-
شرائح عمرية مقسمة من 18 إلى 60+.
-
توزيع جغرافي يغطي 13 منطقة إدارية.
-
فئات دخل متفاوتة (من أقل من 5 آلاف ريال إلى أكثر من 25 ألف ريال شهريًا).
-
مقيمين وسعوديين بنسب تمثل الواقع السكاني.
النتيجة: أظهرت البيانات اختلافًا واضحًا في مستويات الرضا بناءً على مستوى الدخل والموقع الجغرافي، وهو ما لم يكن ليظهر لولا تخصيص العينة بهذه الطريقة الدقيقة.
2. دراسات تمكين المرأة السعودية في العمل (2022-2024)
تم استخدام ZDataCloud في دراسة متعددة المراحل لفهم العوائق التي تواجه المرأة السعودية في سوق العمل. وبفضل التحكم المتقدم في الفروقات الديموغرافية، تم تكوين عينات فرعية متوازنة تضم:
-
نساء من خلفيات تعليمية متعددة (ثانوي، جامعي، دراسات عليا).
-
نساء عاملات في قطاعات تقنية، أمنية، حكومية، وصحية.
-
فئات عمرية متفاوتة (من 22 إلى 55).
-
مناطق حضرية مقابل مناطق ريفية أو شبه حضرية.
النتيجة: أظهر التحليل أن النساء العاملات في المناطق الحضرية ذات الدخل المرتفع أبدين رضا أعلى واستقلالًا وظيفيًا أكبر، بينما واجهت النساء في المناطق الأقل نموًا قيودًا ثقافية ووظيفية لم تُرصَد مسبقًا في الدراسات المعممة.
3. دراسات الصحة النفسية بين المقيمين (2023)
في دراسة على مستوى الرياض وجدة والدمام لفحص مؤشرات التوتر والقلق لدى السكان المقيمين، استخدم الباحثون ZDataCloud لضبط العينة وفقًا للجنسية، ونوع العمل، وساعات الدوام، والدخل الشهري.
-
تم استهداف جنسيات آسيوية (بنغلاديش، الهند، الفلبين) وأفريقية (السودان، نيجيريا).
-
تم تصنيف العينات بناءً على عدد سنوات الإقامة ونوع الإقامة (عمل، عائلية).
-
ربطت البيانات بين الجنسية والوضع القانوني ومستوى الصحة النفسية.
النتيجة: كشفت الدراسة عن فجوات ملحوظة في مؤشرات القلق والاكتئاب بين المقيمين من ذوي الدخول المتدنية، والذين يواجهون تحديات قانونية في تجديد الإقامة، وهي بيانات يصعب رصدها بدون أداة تتيح هذا المستوى من التحكم التفصيلي.
يمثل إدماج الفروقات الفردية في البحث العلمي تحوّلًا من الوصف الكمي إلى الفهم النوعي العميق، الذي يعترف بتعددية التجربة الإنسانية وخصوصياتها الثقافية. في السياق السعودي والعربي، تصبح هذه الفروقات أكثر حدة، وأكثر تأثيرًا، وأكثر ارتباطًا بالعدالة المعرفية والتمثيل العلمي. وحين يغيب هذا الإدماج، تُنتج معرفة معزولة عن الواقع، تُهدر الموارد، وتُقزّم إمكانات التحليل. إن إعادة هيكلة المنهجية البحثية لتكون أكثر تقاطعًا ووعيًا بالاختلافات، هو ليس ترفًا أكاديميًا، بل ضرورة علمية وأخلاقية لضمان أن يكون العلم خادمًا للواقع لا متعاليًا عليه. من هنا تبدأ صياغة المستقبل، لا فقط عبر إنتاج البيانات، بل عبر تمثيل الناس.



















